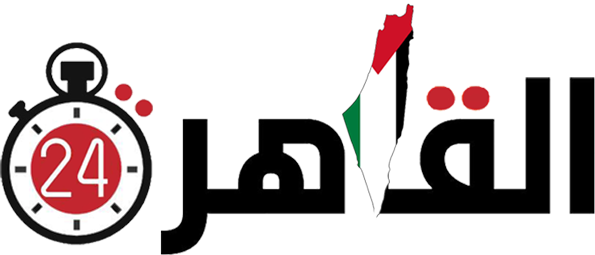تامر إبراهيم يكتب: حازم دياب.. آخر الناجين من الحياة والظافرين بالملكوت

هذا قلمي
وتلك الساقطة من حبره كلماتي
وذاك الذي تنعوه جسدي
وهذه الميتة كانت آخر محطاتي
طوبى للصابرين
“يستمر محلول الكيماوي بلونه الفاقع في الانسياب داخل أوردتي عبر آلة تعذيب تُسمى «الكانيولا»، ثم يستمر لست ساعات محلول آخر يسمى «المابثيرا». ماذا تفيد الأسماء؟. محاليل تليق بمريض أورام يريد منها أن تقتل خلاياه. يتقبّل القتل بصدر رحب، مهما تسبب القتل في تساقط شعر، أو ألم بطن، أو شعور بغثيان، أو إحساس بعجز. وأنا أهم بمغادرة الغرفة في حالة إعياء، وزوجة الرجل الذي هدأت المقصات في بطنه، ترمقني بنظرة التي عرفت أنني مريض أورام، وتنظر لزوجها أن احمد الله الذي عافاك مما ابتلى به جارك”، بتلك الكلمات وصف الصحفي حازم دياب حالته في مقالٍ صحفيٍ نُشر في إبريل من العام الماضي، معاناته اليومين خلال رحلته مع مرض السرطان، الذي أنتصر عليه مساء الأمس، وجعلنا نفقد صحفيًا إنسانًا، نبكيه دهرًا لا يومًا ونُنعيه فرضًا لا تكرمًا.
طوبى لأنقياء القلب
“محدّش بياخد كل حاجة.. معلش. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان على القلب، لا تحاول أن تستخدمهما في مجاملة شخص يعيش مأساة ما. في لحظات المصائب ألفظ كل الكلمات التي لا تصنع شيئًا”. ربما تلك كانت وصية مُبكرة لشخص أنهكته تفاهة الكلمات التي لا تلامس الوجع، فبماذا تفيد الحروف إن كان جدار الروح منكسرًا؟!.
“التآلف مع الألم” عنوانًا جديدًا لمقال آخر كتبه حازم دياب في سبتمبر 2017. كيف لشاب في مقتبل العمر يكتب عن التوحد والألفة مع الألم؟! ولكنه أجاب على هذا السؤال بكلمات تمر من الفم بُعسر إذ قال: “أفكّر في أن لكلٍ ألمه الخاص الذي يستعذب رفقته ليستطيع الحياة”.
طوبى للمحبين
صديقي الذي لا أعرفه “حازم”، كيف حالك الآن وأنت تلامس عتبات السماء، لقد سمعتك تقول من خلال كتاباتك: “أظن أن سبب الحياة يتعلّق بشخص تحبه، قضية تدافع عنها، أم تخجل أن ترحل قبلها، حب تعيش على ذكراه، رفقة تعينك على الاستمرار، شغف بشيء لا ينقطع، حرية تحلم بأن تسود، أو استمرار في الحياة عالة لا تضيف شيئاً وتخشى من الإقدام على تجربة تخليصك من روحك، لواعظ ديني أو لخوف بشري”.
نسيت ان تكتب في مقالك “ثلاثية الحياة والموت والانتحار” الذي نُشر في أكتوبر 2015، عن سبب الرحيل دون سابق إنذار، عن كيف نتحمل فقدان شخص مثلك دون وداع يليق به، نسيت أن تكتب كيف تكون لحظة إنكسار القلم حزنًا على أصابع تحللت بفعل الألم قبل التراب؟!..نسيت تكتب كيف يكون الحب موصولًا بين قلوب أناس لم يلتقوا ولو لمرة واحدة وأوجعهم فراق أحدهم؟!
طوبى للغرباء
في أغسطس 2018 أي قبل 4 أشهر من رحيل صديقي الذي لم التقيه يومًا، كتب حازم مقالًا بعنوان “عن توحّش الصعيد وأضواء العاصمة المبهرة.. من أوراق مهاجر صعيدي”، ولأني مثله وهو يشبهني وكلانا مهاجرون من الصعيد نحو العاصمة الباهرة القاهرة، تقربت أكثر إلى قلب صديقي الذي لم أعرفه يومًا.
قال حازم: “كبرت في الصعيد غريبًا. انطوائي بما وطّد لأغلبية أهل البلدة بألا تعرفني وتفاجئ بانتمائي للعائلة في المناسبات”. طفلٌ نشأ غريبًا وسط أهله وما كان لشغفه سوى أن يقوده لهجرة أخرى بغربة جديدة.
يضيف حازم في مقاله: “حين انتقلت للقاهرة منذ سبع سنوات كنت هائما كأغلب المهاجرين. أبحث عن فرصة في غير مجال دراستي. أقبض القليل من المال، وأتعرض لضغط المدينة التي لا يتوقف أهلها عن التبرم ومركباتها عن الضجيج. الفشل هنا يعني تغيّر المستقبل للأبد، والرجوع خطوة للجنوب مرة أخرى هو الهاجس الذي يحرّك الصعيدي المنتقل حديثا للعمل في أي شيء. أعرف أصدقاء خريجي جامعات وكليات قمة اضطروا للعمل كعمال و”صنايعية” لمجرّد كسب المال الذي يعينهم البقاء وسط من لا يرحم. في بلدتك لن تنام من غير عشاء. لكن هنا يمكن لبطنك أن تئن من الجوع دون أن تجد من يخرسها”.
طوبى للصحفيين
هُنا في بلاط صاحبة الجلالة، كم من شهيد أسقطته قسوة الكلمات، وكم من ضحية قاده شغفه نحو الهلاك، وكم من نفسٍ أنهكها كذب المسؤولين وتبدل الوجوه والخطابات وبقاء المضمون كما هو أحمق، كما من كلمة حق لم تقال وكم من معلومة قادت الباحثين عنها إلى الهاوية، كم من مجد صُنع وكم من تاريخ خُلد، وكم من أثمان دُفعت نظير كل هذا وذاك.
“كاتب هذه السطور في يوم تعرّف عبر قريبه على موقع إلكتروني يدُعى “بص وطل” يتيح الكتابة عبر الإنترنت في مجالات مختلفة، وكان للموقع صيت في وقت لم يكن لوسائل التواصل الاجتماعي فيه حيز يذكر في الإنترنت. كان هناك انتشار هائل لمواقع شبابية ومنتديات أدبية فرزت الآن جيلا من أهم الكّتاب على الساحة. كان يكتب في “بص وطل” د. أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق وكثيرون ممن كان مجرّد رؤيتهم في معرض الكتاب أو شاشة التلفاز حلمًا بعيد المنال. بعد عشرات المحاولات الفاشلة بدأ الموقع في استقبال أخبار منّي. كان رؤية الاسم: حازم دياب على الشاشة يصل بي للاكتمال الذي كنت أصبو إليه. أنا أريد أن أكمل بهذا المجال ولن أرتدي بذلة عنق يوميا موظفًا”.
تلك الكلمات كانت جزءًا من مقال كتبه حازم دياب بعنوان: “في الفالنتين.. اعترافات عن الحب والصداقة” والذي نُشر قبل وفاته بشهر واحد، وعبر فيه حازم عن شعوره كصحفي وكيف خاض تلك التجربة ولكنه لفت الانتباه بشكل اكبر إلى الحب والصداقة في حياته.
هبة خميس..فتاة أتت من الإسكندرية لتسكن قلب حازم وتُحسن سُكناها، كانت حبيبة صم زوجة ولكن الأهم أنها أجادت دور الصديقة في أحلك الظروف، فيقول حازم: “الزمان: ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦..موعد أول جلسة كيماوي بعد معرفة إصابتي بالسرطان. بداية أن تعبس الحياة في وجهنا. أحسب المدى الزمني. أنظر للتواريخ المولع بذكرها. ست شهور فقط قضيتها كأب دون ورم يجثم عليّ، ويحوّل الفتاة هبة الحبيبة والزوجة إلى دور الصديقة التي تساند صاحبها المريض وليست مجرّد الزوجة التي تدعم بشكل خاص. لا أعرف كيف أصبحت هبة أكثر صداقة إليّ بعد المرض. هبة فتاة يغلب عليها الارتباك لو وجّه إليها شخصان الحديث في وقت واحد. منذ ذلك اليوم ألقيت إليها بكل ضعفي وهواني وطفولتي. أخبرتني: لنعش اليوم بيومه. لكن الأيام مؤلمة يا هبة، وتحملنا لها كان من ضروب المستحيل”. سنلتقي قريبًا عزيز حازم، أيها الصديق الذي لم ألتقيه يومًا، ولكني أحببته من عطر سيرته، كيف حالك الآن، أظنك لا تتألم ولا تحزن من نظرات الشفقة إليك، أظنك لم تعد تنتظر راتبك الشهري الذي لن يكفيك شهرًا، أظنك لست في حاجة إلى خوض معارك فرضت علينا كشباب ولا نعلم لماذا نخوضها وندفع أثمانها وحدنا ونحن لا ناقة ولا جمل لنا بها، أظنك مبتسم تتأمل السائرين على جنبات الطرقات والأحبة الجدد على المقاهي والصحفيين في صالات التحرير، أظنك ترى طفلك وزوجتك وربما الأن يبكونك ويفتقدونك ولكن في الغد ستفخر بهم ويفخرون بك. صديقي حازم، هزمك السرطان ولكنك أنتصرت على تلك الحياة، فبموتك نجوت مع آلامها وضغائنها وحروبها القبحية، بت آخر الناجين منها وآخر الظافرين بالملكوت، سنلتقي يومًا وسأحضر معي قلمًا وأوراق لندون من الأعلى كيف أضعنا حياتنا في كل تلك الترهات..سنلتقي قريبًا.