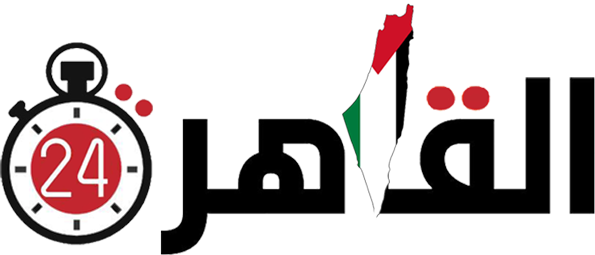صورة الرئيس عن نفسه ودوره
"في سنوات السجن الطويلة في الزنزانة (54) التقى بذاته، عرف ماذا يريد؟ ولماذا يناضل؟ وحدد أهدافه وكوّن لنفسه فلسفة في الحياة، بعد قراءات عديدة وعميقة في التاريخ والسياسة والفلسفة والدين. وبعد ذلك حدد طموحه، وهو الرضا عن النفس، الرضا الحقيقي، الذي يميز بين العرض الزائل والجوهر الأصيل. إنها نظرة فلسفية عميقة فيها آفاق التصوف".
بتلك الكلمات وصف الراحل الأستاذ موسى صبري شخصية وفكر وغاية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في كتابه الشهير الذي حمل عنوان "وثائق 15 مايو".
بالطبع لم يكن ذلك الوصف بالكامل من نسج خيال الأستاذ موسى صبري، وأكاد أجزم أنه قد سمع بعضه من الرئيس السادات الذي اقترب منه كثيرًا ودخل في حورات مستمرة معه. وأن تلك كانت رؤية وصورة الرئيس السادات لذاته وحياته وغايته التي حاول إيصالها للناس.
وهذا يجعلني أطيل التأمل في موضوع صورة الحاكم عن ذاته ودوره، وتأثيرهما في إدارته للدولة، وانعكاسهما في خياراته وسياساته وقراراته.
خاصة الحاكم الذي يأتي في لحظة تاريخية مليئة بالتحديات والمخاطر التي تستهدف وطنه، ويشعر معها أنه وصل للحكم بتوفيق وترتيب قدري، وعليه أن يقوم بواجبه الوطني، ويتحمل بشجاعة المسؤولية الكاملة للوصول بالوطن وشعبه إلى بر أمان.
وبالعودة إلى تاريخنا المعاصر نجد أن الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات – رغم ما بينهما من اختلافات في الشخصية – كانا يملكان تكوينًا سياسيًا وفكريًا مميزًا، وإحساسًا بثقل المهمة الوطنية والتاريخية الملقاة على أكتافهما، وكان كل منهما رجل قدر بامتياز.
كما كانا أصحاب وعي تاريخي وسياسي، ويملكان رؤية وفلسفة في الحياة، حددت لهما بعد وصولهما إلى منصب رئاسة الجمهورية، اتجاه السير والأهداف التي يجب تحقيقها للوصول بالوطن وناسه إلى بر أمان، بصرف النظر عن نجاحهما في تحقيق ذلك من عدمه.
أما الرئيس محمد حسني مبارك، فقد تحلى بسمات شخصية هي أبعد ما تكون عن عالم الفكر والوعي التاريخي والسياسي، وصورة رجل القدر؛ ومرجع ذلك تكوينه الشخصي والمهني، وأنه وجد نفسه "رئيسًا للدولة" فجأة دون أن يملك الطموح لذلك؛ ولهذا أصبحت غايته "تدوير" الدولة ومؤسساتها واقتصادها، بما يضمن له الاستقرار في الحكم، والتمتع هو أسرته بأبهة الرئاسة، حتى ولو صار هذا الاستقرار جمودًا يبدد الإمكانات والدور والمكانة.
ثم جاءت ثورة 25 يناير – بما لها وما عليها - لتُنهي سنوات حكم مبارك، وتُفشل مشروع التوريث، وتلقي بالوطن في متاهة تحولات سياسية واقتصادية وأمنية وضعت الدولة المصرية ومؤسساتها على مشارف السقوط.
في تلك المرحلة بدأت الأقدار في نسج الدور التاريخي للواء عبدالفتاح السيسي، الذي كان مديرًا للمخابرات الحربية في ذلك التوقيت، وكان هذا الجهاز بعد الهزة العنيفة التي حدثت في معظم الأجهزة الأمنية الأخرى، هو أكثر الأجهزة الأمنية حضورًا وتأثيرًا في إدارة ملفات الدولة، ومواجهة المخاطر التي تتهددها.
ثم تتابعت الأحداث وصولًا إلى قيام ثورة 30 يوينو، وتحالف الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية لإسقاط حكم الإخوان، ومعها سطع نجم وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، الذي تطلعت إليه عيون وعقول وقلوب المصريين، الذين وجدوا فيه مخلِّصًا من حكم الإخوان، وبطلًا وطنيًا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية التي تحتل في قلوب وعقول المصريين مكانة كبيرة.
وبعد فترة انتقالية لمدة عام أدار فيها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور شئون البلاد، جاء المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية بانتخابات نزيهة، واستبشر أغلب المصريين بنجاحه خيرًا، وتمنوا من الله أن يوفقه في معركة إعادة الأمن والاستقرار إلى الدولة، ومعركة التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.
وهنا فيما أظن، بدأت مرحلة جديدة في حياة ورؤية الرئيس السيسي لنفسه ودوره، ومسؤوليته الوطنية والتاريخية. مرحلة تجلى فيها على أوضح ما يكون البُعد الصوفي والاستراتيجي في شخصيته وفكره، وأصبحا هما الموجهين لمعظم خياراته وقراراته.
أما البُعد الصوفي، فقد تجلى في يقينه التام بأن الله هو الواهب والنافع والمانع والضار على الحقيقة، وهو مَن أكرمه بشرف ومسؤولية حكم مصر. وأن الله المطلع على ما في قلبه، ويعلم صدق نواياه، ومدى حرصه على تحقيق خير هذا الوطن ومؤسساته وشعبه.
وأنه لا مجال لشكر الله على نعمه التي لا تُعد ولا تحصى في حياته، وبعد وصوله لمقعد الرئاسة؛ إلا بالعمل المتواصل على خدمة المصريين، وبالسعي لإعادة بناء مؤسسات واقتصاد الدولة، وتدعيم قوتها العسكرية والأمنية، بما لا يعرضها للتهديدات والمخاطر التي واجهتها بعد 25 يناير 2011 مرة أخرى.
أما البُعد الاستراتيجي، الذي تكوّن عبر حياته ودراساته وخبرته العسكرية، فقد تجلى بعد اطلاعه على كافة ملفات الدولة المصرية منذ ثورة يناير 2011، وإدراكه أنها تواجه أزمة شديدة، وأن إنقاذها وإعادة بنائها لن يكون إلا بالمواجهة الحاسمة، والمعالجة الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية المتراكمة منذ عقود طويلة.
وأُرجح أن منطق تفكير الرئيس السيسي في كيفية التعامل مع واقع الدولة المصرية المأزوم، قد تأسس انطلاقًا من يقينه بأن البراعة في إدارة أزمة الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011، تكمن في تحويل ما تتضمنه من تهديدات ومخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية، ووضع حلول جريئة وشجاعة، لم يكن من الوارد اللجوء إليها في الظروف الطبيعية، وصولًا لهدف استراتيجي واضح، هو إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وضمان وحدتها واستقرراها، وتحسين الوضع الاقتصادي والعسكري لمصر، لاستعادة دورها ومكانتها في المنطقة.
وهنا نجد الدافع الكامن خلف الكثير من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة، التي اتخذها الرئيس، وأثرت إلى حد كبير في شعبيته بالشارع المصري، وخلقت له كثيرًا من الخصوم والمعارضين، ومع ذلك لم يتردد لحظة في اتخاذ هذه القرارات واستكمال تلك الإجراءات؛ لأنه كان على يقين من أنها مثل الدواء المر، الذي يكمن فيه في نهاية المطاف صالح البلاد والعباد.
تبقى في النهاية كلمة حق يجب أن تُقال، إن الرئيس السيسي سواء اتفقت أو اختلفت مع سياساته وخياراته وأولوياته، هو رجل دولة مصري وطني نظيف اليد، منزه عن الهوى والغرض الشخصي في دوافعه وقرارته وغاياته.
وقد اتخذ بشجاعة قرارات صعبة، وانتهج في الملف الاقتصادي والاجتماعي والأمني سياسات تحاول تصويب أخطاء أنظمة الحكم السابقة، ليقينه بأن إعادة إنتاج سياسات وخيارات الماضي، سوف ينتج عنه المزيد من التدهور الاقتصادي، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتبديد مقومات المكان ومحددات القيمة والمكانة.
ولهذا أظن أن التاريخ سوف يُنصف الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا، وسوف يجعله أحد "رجال الأقدار" العظماء في تاريخ هذا الوطن العظيم، بصرف النظر عن الأحكام السيناريوهات والنهايات التي يُصدرها ويرسمها ويتمناها لشخصه ولنظامه بعض خصومه ومعارضيه.