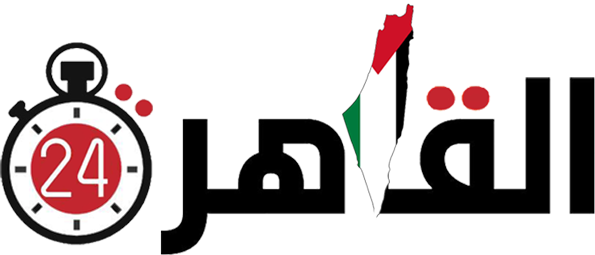ما منحته الإسكندرية للجنوبي أمل دنقل
"أحب المطر، أحب أن يغسل وجهي، ويغرق شعري ورأسي. في الصعيد نتمنى قطرة منه، وهو هنا في هذه المدينة مباح حتى للبحر الفسيح المليء بالماء، في حين تظل الأرض عطشى بطول الصعيد".
هذا جزء من حوار دار بين الشاعر الجنوبي الراحل "أمل دنقل" والراحل الأستاذ "سليمان فياض" وهما يسيران معًا تحت المطر في شارع بورسعيد بالإسكندرية شتاء عام ١٩٦٢.
وهو حوار يُلخص تصوري عن "الجغرافيا غير العادلة"، وكيف تُصبح ثرية وحميمية في بعض المناطق من البلد الواحد، وفقيرة وقاسية في مناطق أخرى. وكيف يؤثر هذا الاختلاف بالإيجاب والسلب على أرواح وعقول وأفكار وثقافة الناس الذين يعيشون في سياق تلك الجغرافيا.
وأظن أن شاعرنا الجنوبي "أمل دنقل" كان يعي تمامًا سمات وقيود وقسوة هذه "الجغرافيا غير العادلة"؛ ولهذا جاء حديثه عن "المطر" في كلماته السابقة مع سليمان فياض حديثًا رمزيًا متخمًا بالكثير من الدلالات عن عمق إحساسه بقسوة الجغرافيا والمناخ والحياة في الصعيد، وكيف يؤثر ذلك بالسلب على عقول الناس وأرواحهم وشكل ونوعية حياتهم وثقافتهم وخياراتهم.
وأظن كذلك إن إحساسه بقسوة تلك الجغرافيا، كان دافعه الأول للهروب منها، والسفر إلى الإسكندرية عام 1962 ليقضي بها عامين، كان لهما أعظم الأثر في إثراء تكوينه الفكري والثقافي، قبل انتقاله للعيش بالقاهرة، وإقامته بها حتى وفاته عام ١٩٨٣.
في هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور جابر عصفور عن علاقة أمل دنقل بالإسكندرية في مقال له بعنوان "إسكندرية أمل دنقل" نُشر بجريدة الأهرام في يناير 2017:
"لمدينة الإسكندرية فضل كبير على شعر أمل دنقل، فهي التي نقلته من وعي القرية (القلعة) والمدينة الصغيرة في الجنوب (قنا) إلى وعي المدينة الكوزموبوليتانية الزاخرة بالتنوع الخلاق للأعراق والجنسيات".
إذن "الوعي المديني" الثري ومتعدد الأبعاد، هو جوهر ما منحته الإسكندرية لأمل دنقل، وهو الذي حرر روحه وعقله من القيود الفكرية والثقافية التي تربى عليها في قريته الجنوبية، ومدينته الصغيرة.
وهو ايضًا الذي أثرى حياته وثقافته وشعره، وجعله روحًا جنوبية وسكندرية ومصرية وإنسانية منفتحة، ترفض الاستسلام لقبح وظلم الأمر الواقع، وتدعو للتغيير والحداثة والتنوير، والجمع بين الأصيل الذي يُحافظ على الهوية، والمعاصر الذي يُجدد ويثري الوجود الخاص والعام.
وللأسف الشديد، فإن هذا الوعي المديني لا يزال - بعد كل تلك السنوات- غائبًا عن الصعيد بتأثير الجغرافيا القاسية، وبتأثير التقاليد المحافظة المنغلقة، وشيوع أنماط الفهم المغلوط للدين ووظيفته في الحياة.
ولا يزال الصعيد رغم الجامعات الإقليمية العديدة التي أنشئت فيه، صاحب "وعي قروي وريفي"، وسلفي الفكر والرؤية حتى في الجزء الأكبر من قياداته السياسية والتنفيذية والمجتمعية والجامعية، التي كان المفترض أن يقع على عاتقها إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وتفكيك أنماط وقيود ثقافته التقليدية المعوقة للتطوير والإصلاح والتغيير.
وبناء على هذا، فإن الأرض لا تزال عطشى بطول الصعيد لمطر التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُغير حياة أبنائه للأفضل، وتُقلل من قسوة بيئتهم، وتُثري وجودهم، وتنقلهم من الوعي الريفي المُغلق إلى الوعي المديني المفتوح، وتمنحهم فرصًا جديدة للعمل وعيش الحياة والاستمتاع بها.
وبهذا يمكن أن نقضي على عزلة الصعيد، وعلى إحساس ابنائه التاريخي بالمظلومية. ونقضي كذلك على تغريبة الصعيدي المستمرة عن أرضه بحثًا عن عمل يحقق له الاستقلال والكرامة، وعن جغرافيا أكثر رحابة، وأفق أكثر اتساعًا للتحقق المادي والمعنوي.