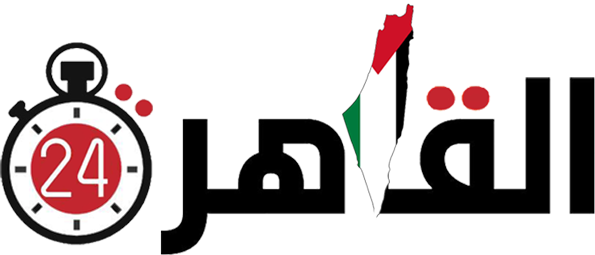رئيس اتحاد كتاب مصر يهاجم جابر عصفور: الخطاب النقدي في كتاب زمن الرواية متهافت

شن الدكتور علاء عبد الهادي هجوما شديدا على الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، واصفا كتاب زمن الرواية لجابر عصفور بالمتهافت، وذلك قبل ساعات قليلة من انعقاد الملتقى الدولي جابر عصفور الإنجاز والتنوير بالمجلس الأعلى للثفافة صباح اليوم.
وكتب علاء عبد الهادي مقالا مطولا على صفحته الشخصية بعنوان: تهافت الخطاب النقدي في كتاب زمن الرواية لجابر عصفور قراءة ثقافية: الوظيفة وملكة الحكم النقدي. وحراص على ألا يكون المقال مجتزئا ننقل ما كتبه علاء عبد الهادي بنصة وجاء فيه:
علاء عبد الهادي: جابر عصفور ناقد إشكالي
في البداية يعد جابر عصفور ناقدًا إشكاليًّا، وسبب ذلك متعدد في الحقيقة نظرًا إلى تمتعه بحس نقدي ذكي وقوي يمنح كتاباته حضورًا لدى جموع النقاد، كما يثير أسئلة مهمة لدى أهل الصنعة ممن هم أكثر اقترابا إلى المجال النقدي الحديث في ارتباطه بالدرس الفلسفي، ممن يحملون دائمًا نظرة متشككة، تحب القراءة بمعناها التفكيكي الفاحص أكثر من محض الاستيعاب، والمجاملة بالتصفيق أو الانبهار والإعجاب.
الوجه الآخر من هذه الإشكالية هي تفاوت الخطاب النقدي لدى جابر عصفور من الإجادة وهي كثيرة إلى التهافت، لكن المشكلة لا تكمن في خطابه النقدي فحسب بل تكمن في منهجه الذي لا نكاد نتبين له حضورًا واحدًا صحيحًا متكاملا في معظم أعماله، وهي ملاحظة تحتاج إلى درس وتمحيص لكنني لا أعدو الحق إذا قلت إنها تنطبق على معظم ما يسميهم الوعي النقدي العام بنقاد الحداثة، فمن النادر أن نجد لأحدهم دراسة نقدية لافتة طبقت المناهج التي بشروا بها! ومنهم نقاد كانوا يترجمون وهم يؤلفون ويؤلفون وهم يترجمون! لا فضل لهم فيما نقلوه والذي لم يخل من سوء فهم أو انتحال وتشويه، وذلك سنتناوله تفصيلا في دراسة مستفيضة لاحقًا،
أما الوجه الثالث لجابر الناقد الذي يجعل أي حكم نقدي عن أعماله شائكًا فهو تقلده مناصب رفيعة في وزارة الثقافة خلقت له مجموعة كبيرة من العلاقات العربية والولاءات فاشتبك الحكم النقدي من خلالها مع كل من المكان الاجتماعي، والمكانة النقدية دون تمييز، ودون أن يقدم الدارسون –وهذا حق أعمال جابر على الوعي الثقافي المصري- أية قراءة ثقافية تتماس مع تيار الدراسات الثقافية والنقد الثقافي لحراك المكان والمكانة! ولسؤال أساس: كيف أثرت الوظيفة العامة بقوالبها النمطية في ملكة الحكم النقدي للناقد الأكاديمي الممارس؟
وهذا ما سنتماس معه في هذه القراءة السريعة لكتاب جابر عصفور زمن الرواية وليس لمنجزه. فهذا التناول يخص كتابًا بعينه ولا يخص الكاتب أو مجمل أعماله.
دعونا نعترف مرة ثانية أنه قد طرأ تغير مهم على الثقافة الأدبية، فإذا كان العالم الحديث قد اعتاد أن يستهلك في ثقافته كلمات، فهو الآن يستهلك صورًا. وهذا يطرح على أي طرح منهجي يرتبط بدراسات النوع سؤالًا إشكاليا لا مناص منه ولا إجابة جامعة مانعة له ترتبط بحدود تعريف كل نوع بعد تداخل الأنواع من جهة، وبعد تفكيك سيطرة النظرة الجزئية لنظرية النوع بمحمولاتها النقدية الكلاسية التي قامت تاريخيًّا على معاينة واقع موضوعي في بيئة غربية في أساسها لم تحترم الخصوصيات الثقافية وأنواع الكتاب والفن لشعوب احتلتها وكانت أقل تقدما معرفيًّا وثقافيًّا وفنيًّا من جهة أخرى! بحيث تحول أصل النوع الأدبي أو الفني إلى النوع ذاته وكأننا أمام داروين جديد لكنه هذه المرة يقدم أصل أنواع، جديدًا على المستوى الثقافي! والسؤال هنا: ألا يحق لنا بوصفنا نقادًا ننتمي إلى بيئة ما بعد- كولونيالية أن نسائل هذه المسلمات الثقافية القارة، وأن نعيد قراءتها أو تشكيلها؟ وهذا سؤال يطرحه الكتاب من عنوانه: لأننا في الحقيقة لا نكاد نتبين هذا المعنى العلمي الخالد المتفق عليه لدال الرواية وفق اختلاف المناهج وعلوم السرديات والرؤى في تصنيفاتها: الحداثية، والحداثية العليا، ومابعدهما، لكننا لن نتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل، ربما نقوم بذلك في مقال لاحق.
لقد أصبحت الممارسة الأدبية أكثر شعبية، بسبب تطور الوسائط البصرية –الحاسوب بخاصة- تلك الوسائط التي غيرت شروط التبادل الأدبي للسلعة الثقافية، وهذا ما أنتج شروط مشروعية جديدة، ونَشَرَها لصالح تواصل إنساني أعمّ، لا يخضع لشروط الإنتاج النوعية القديمة، ولا ينتمي إلى الكتابة الأدبية المعتادة القائمة على الكلمة فحسب، وهذا تحدٍ جديد سيواجه النقد التقليدي في القريب العاجل، وقد زاد هذا التغيير الحادث في شروط إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها، من التقليل من كفاءة هذه السلع على المستوى التقليدي، أو من ضوابط مشروعيتها الأدبية والثقافية من ناحية، كما أسهم في أزاحة عدد كبير من العراقيل التي كانت تمنع منح هذه الكتابات شرعية ثقافية، وبالتالي تحجبها عن التداول لصالح محترفين كانوا يستولون على السوق الثقافي، عبر خلق احتياجات أدبية خاضعة لشروط سلطة تاريخية وإنتاجية ما، ولأثر اجتماعي أو طبقي يملك رأسمالًا رمزيًا يريد تعميمه وتسليعه من ناحية أخرى، حيث كُسرتْ مشروعيةُ هذا الاحتكار للسلعة الثقافية عبر قبول عدد كبير من المتلقين بالحد الأدنى من كفاءة المنتج الأدبي وشروط إنتاجه، من أجل تواصل إنساني أكثر انتشارًا، فأصبحت الممارسة الأدبية أكثر شعبية، حين جُرِّد الإنتاج الثقافي والأدبي من احتكاره المشروع، بحيث تناقصت عراقيل المشاركة الجماهيرية الواسعة في تداول الأدبيات على مستويي الإنتاج والاستهلاك، تلكم المتطلبات التي منحت –عبر عصور عديدة- شرعية مهيمنة لتصنيفات نوعية أدببية وفنية من جهة، ولحاملي شروط بأعينها يحتلون أمكنتهم في المجال الأدبي أو الثقافي بوصفهم حراس نوع من جهة أخرى، ممن امتلكوا طويلًا -بناء على ذلك- مشروعية المنع والمنح على المستوى التداولي لصالح الثنائية: هواة/ محترفون، أمام الثنائية: متلقون/ نقاد، أولئك الذين كانوا يستولون على السوق الثقافي عبر الحفاظ على سمات ثابتة لمنتجات رمزية، خلقت مستهلكيها التقليديين، وظلت خاضعة لسلطة المجال التاريخية وتصنيفاته على مستويي النوع الأدبي والفني.
إن عزوف كثير من الأعمال الإبداعية المصرية المعاصرة بخاصة، والعربية بعامة، عن تناول المضامين الإبداعية التقليدية، وعن الاستمرار في استخدام الأشكال الأدبية القديمة والمألوفة لدى القراء والنقاد يحتم على الخطاب النقدي المعاصر، أن يتبنى تناولات نقدية موازية لهذه الأعمال، التي تحتفي بالهجنة على مستوى النوع، تناولات تتحلى بقدر من المغامرة، لتقديم خطاب مواز لشراسة النص الإبداعي الذي يتعاملون معه.
يستطيع المبدع زعزعة القواعد والخروج من إسارها، أما الناقد الحق فهو من يتفهم مقدار هذا الخروج وطريقته، كونه حارسًا للحدود الجمالية، وهو ما تحمله الأجيال النقدية الجديدة التي أتابع أعمالها من وعد بالاكتمال، ومن هم بالتأصيل. إن كل تأجيل في التناول النقدي لكتاب إبداعي متميز يعني خلق فجوة جمالية في فضاء الاستقبال الأدبي، وترك مساحة فارغة، تضع جزءًا مهمًا من إنتاج إبداعي موضع التجاهل، مؤجلة تأثيره لصالح دعاوى الكتابة المحايدة التي لا تسائل شيئًا، محتمية بالتوفيق والوسطية، ومنشغلة بإنتاج خطاب إبداعي هزيل يقلد إبداع الأقدمين ولا يوازيه، تحت دعاوى كاذبة منها المحافظة على التراث، ووظيفة الإبداع في مجتمعه، وخلافه; إن حيوية العمل النقدي هي التي تخلق للإبداع فاعلية في الواقع الإبداعي المعيش، وهي فاعلية ثقافية في مقامها الأول، حيث أدى خفوت صوت النقاد في جوقة الأدب المعاصر إلى ارتفاع أصوات أساتذة النقد! الذين اكتفوا بنقل الحداثة دون أن يمارسوها، أو يطبقوها في أعمالهم، فألفوا وهم يترجمون، وترجموا وهم يؤلفون كما أسلفنا، فأنت لا تكاد تتبين الحد الفاصل بين الترجمة والتأليف في نصوصهم التي تناولت المذاهب النقدية الجديدة، وهذه مقدمة ضرورية لتناولات قادمة تهتم تباعًا بتبيان عوار هذه النصوص، وأصالتها الزائفة، وكشف المنقول منها والموضوع.
هكذا يصبح الحكم بأننا في زمن الرواية حكمًا يخلو تماما من الحذر العلمي الذي كان يجب أن يتوخاه الأكاديمي عند إطلاقه الأحكام، خصوصًا أنه حكم يتعلق بالمستقبل، فما المقصود بالرواية؟ ولم تعد الأنواع الأدبية مكتفية بالتلامس، بل تتداخل حدودها الآن أو تكاد، وأي زمن هذا الذي سيتنحى فيه الشعر عن الواجهة لصالح السرد في القصة والرواية؟ وما مقداره؟ بعد أن اختلف حِسّنا بالزمن عما كان عليه من قبل; إن الحكم على المستقبل بناء على معاينة واقع موضوعي هو سلوك غير حذر، ويخلو من الدقة العلمية في آن، أما مدّ خطوط التاريخ المعيش على استقامتها استشرافًا للمستقبل فنتيجته مفعمة بالخطأ على الدوام.
وقف من وراء هذه المقولة الشائعة (نحن في زمن الرواية) كتابة وسلوكًا في مصر كتاب الدكتور جابر عصفور زمن الرواية، قبل هذا الكتاب بسنوات، صدر كتاب آخر له عنوان شبيه، دون أن يرمي إلى معنى زمن الرواية على النحو الذي تبناه جابر، وهو كتاب د. محسن جاسم الموسوي، وأغلب الظن أن عصفور اقتبس عنوان كتابه من الموسوي.
دافع معظم من قرأ كتاب زمن الرواية من أصدقاء عصفور المقربين، عن الكتاب بوصفه كتاب سوق، من الظلم أن نحاكمه محاكمة أكاديمية، فهو لا يزيد - في رأي عدد من النقاد العرب والمصريين- على كونه ثرثرة نقدية، قد يكون هذا صحيحًا، ولكن تظل لهذا الكتاب دلالة ما إذا ما اهتممنا فيها -ثقافيًّا- بالكشف عن الممزوج بين ملكة الحكم النقدي الأكاديمي ومعايير التقويم المتبعة في الوظائف الإدارية في المؤسسات الرسمية للدولة! وتأثيرها غير الواعي بفكر الأكاديميين العاملين في هذه المؤسسات، خصوصًا في دولة مركزية مثل مصر ذلك لأن عمل الأكاديميين في المؤسسات الرسمية للدولة -بسبب هذه المركزية- هو عمل أدخل في السياسة منه في الثقافة، وهذه ملاحظة مهمة في سياقي هذا، وأنا أحاول أن أكشف بطلان هذه الدعوة التي دفع بها كتاب زمن الرواية.
كان هناك في رأيي إرغام نقدي لا شعوري هو الذي وجه خطاب جابر إلى تهافت حكمه النقدي في معالجته للموضوع في هذا الكتاب، أو في وجهة نظره بعامة عن الشعر، انتقل إليه هذا الإرغام من معايير مؤسسية اكتسبها من وظيفته، وسأختصر رؤيتي بداية بالعنوان على النحو الآتي، يبدأ عنوان الكتاب بمفهوم خاطيء للزمن، وللرواية، يفترض ثبات الرواية على ما هي عليه، فضلًا عن ثبات الزمن! بحيث قام اتجاهه في قراءة وضع الشعر والرواية المعاصرين، على رؤية ساكنة أحادية، دافعًا ببنية الكتاب إلى محاولة إثبات أن الزمن هو زمن الرواية، وهذا لا يعني أن هذا الزمن زمن الرواية لا شعر فيه، فهذا ما لم يدفع به الكاتب، وما لا يمكن أن نظنه فيه أيضًا، أي أن جابر في بداية نصه لا يتعدى كونه واصفًا لما هو قائم بالفعل، دون أن يدعو بالضرورة إليه، أو دون أن يتنبأ باستمراره، لا غبار حتى الآن على صحة تناول القضية المطروحة، لكن ما أثار عددًا من الأكاديميين والشعراء هو أن الكاتب جاوز الوصف إلى التنظير مستندًا في ذلك إلى مجموعة من المعايير الخاطئة، وهذا يشي بأن هذا الكتاب أدخل في الدعوة، منه في الوصف، أي أنها دعوة اختلطت بنبوءة ما، برغم أن الرؤية ابتدأت واصفة لما هو كائن، وهذا ما منح خطاب عصفور نزعة غائية، حاولت إضفاء الطابع الموضوعي على نزوعه الشخصي الخاص، فظهر التهافت واضحًا في بنية خطاب جابر النقدي من جهة، وفي ضعف منطق دعوته إلى زمن الرواية من جهة أخرى.
-كانت أبرز معايير المؤسسة التي انتقل تأثيرها إلى العقل النقدي للمؤلف وضوحًا، هي ميوله العديدة في الكتاب إلى التنميط، فقد بدأ باختزال الحضور المتعدد المشتبك للظواهر الأدبية، ولوقائع النوع الأدبي المتجه إلى الهجنة والالتفات النوعي، وصبه في فكرة التمثيل، وهي فكرة مؤسسية وسياسية في أساسها; هناك نوع يتكلم نيابة عن بقية الأنواع، على الرغم من أن التمثيل ينقل التحليل من المستوى الاجتماعي/ الأدبي بكل تناقضاته، إلى السياسي في مفاهيمه ذات الشمولية غير المتأثرة بانقسامات الاجتماعي وحراكه!
أما المعيار المؤسسي الثاني الذي سيطر على حكم جابر النقدي فهو ما يستدعي فكرة السلطة، سلطة الرواية على الشعر، من خلال سلوك نمطي في إطلاق الأحكام يربط بين حيازة رأسمال رمزي ما، وحضور نوع أدبي، مدللًا على غياب التكافؤ في توزيع الرأسمال المادي والرمزي بين الأنواع، وهو توزيع يبدو على المستوى الكمي أن الرواية تستأثر فيه بنصيب كبير، وهذه طريقة من طرائق التقويم المعتادة في المؤسسات الرسمية; طريقة لا تقبل الشك بشرعية الحضور،لكنها شرعية تقوم على حجم الكم، لا تقوم على أهمية الكيف، فسيطرت النظرة الاستهلاكية الكمية بوصفها معيارًا للحضور على معايير جابر في إثبات وجهة نظره، دون أدنى اهتمام بأن الأمر يتعدى الكم إلى الكيف، على الرغم من أن حكم الأكثرية ليس حُكْمًا مُحْكَمًا دالًا على الثبات، بل غالبًا ما يكون حكمًا مصطنعًا وظرفيًّا إلى حدّ بعيد.
وارتبط المعيار الثالث في رؤية جابر لزمن الرواية بفكرة تقويم مؤسسية أخرى هي الجائزة، فالجائزة تعني الاعتراف الإعلامي والمؤسسي الرسمي على نطاق كمي واسع، فأضحى عدد المرات التي نال فيها كتاب روائيون جائزة نوبل معيارًا لحضور الرواية في العالم ودليلا في رأيه على انحسار الشعر، دون أن يهتم جابر مثلًا بجموعة من المعايير المعقدة التي تنقض هذا الحكم، منها –على سبيل المثال- صعوبة الحكم –فيما يتعلق بالجوائز الأدبية المختلطة من نوع نوبل- على الشعر نظرًا إلى أن أي حكم جمالي جاد من لجنة تحكيم مختلطة، أو تتكلم بلغة غير لغة النصوص الشعرية الأصلية -موضوع التحكيم- سيكون بالضرورة قائمًا على ترجمة يفقد فيها الشعر الكثير من قيمته، ـ على عكس الرواية- أي أن معيار الموضوعية في نوبل –برغم تهافته- يقل أكثر في الحكم على الشعر لطبيعة عبقرية اللغة فيه غير القابلة لنقل النصوص الشعرية الأصلية إلى نصوص مشاكلة لها في لغة أخرى، وهذا قد يؤدي إلى اعتماد لجنة التحكيم في تقويمها على معايير غير كفاءة النصوص، من هذه المعايير شهرة الشاعر، وموقفه السياسي أو الإنساني، وربما مكانه الجغرافي... إلخ. على نحو يجعل منح جائزة نوبل إلى المسرحيين أو الروائيين [داريو فو الإيطالي، وكيرتس المجري، على سبيل المثال، على الرغم من كونهما من كتاب الصف الثاني في بلادهما] أكثر سهولة من منحها إلى شعراء عالميين في إيطاليا وفي المجر أكثر قوة وحضورًا وموهبة من الاثنين.
- أما المعيار الرابع من معايير التقويم الذي انتقل من المؤسسة السياسية إلى العقل النقدي للأكاديمي الموظف -وعصفور هنا نموذجًا- فهو فكرة النظرة الأحادية الثابتة إلى الزمن، بحيث أصبح الزمن –في ظل سيطرة هذه الفكرة- خطيًّا ضيقًا، لا يحتمل إلا قائدًا واحدًا يملأه بالحضور، مع نفي الآخر/ المعارض الشعري، والرواية هي البطل النافي هنا، ولي دراسة ميتا-نقدية على مفهوم الزمن واضطرابة في كتاب عصفور زمن الرواية خصوصًا في استخدامه لمفهومي الحرية والضرورة، وهما مفهومان يكررهما جابر كثيرًا في أحاديثه، ولا مجال للتوسع في معالجة هذه الدعوة أكثر من ذلك في هذا المقال القصير، ولكنني أردت أن أفند مجموعة من المعايير الخاطئة فحسب، تلك المعايير التي اعتمد عليها جابر في هذا الكتاب، من أجل نقض الفكرة التي قامت عليها هذه الدعوة من جهة، ولتوضيح شروط إنتاجها من جهة أخرى، فليس هناك –وربما لا يوجد- زمن واحد، بل هناك أزمنة متجاورة في آن واحد، وعوالم كثيرة ممكنة; إن رؤيتنا الجاسئة للزمن، وإحساسنا الخطي به، هي وهم نفسي واجتماعي في أساسه، وياله من وهم. ورأيي أن هذا الكتاب من المهم دراسته من منظور النقد الثقافي لتبيان أثر الوطيفة العامة في ملكة الحكم النقدي، وكيف تؤثر الوظيفة الإدارية للأكاديمي على نصه إلى درجة التهافت، وللكتابة بقية.