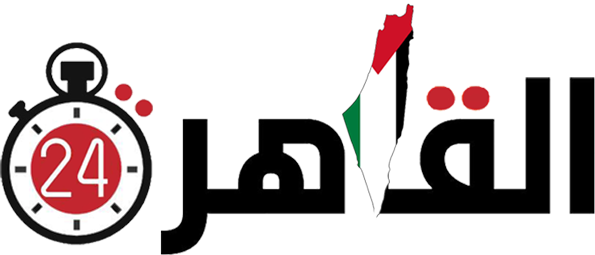عبد الحليم نور الدين أستاذ الأجيال في الآثار المصرية
أتنهد كلما جاءت سيرة أستاذ الأجيال الأثري العظيم، الراحل، الدكتور عبد الحليم نور الدين، ويدور أمام عيني شريط من الذكريات التي لا أنساها أبدًا، فقد تقاطع عطاء الراحل لوطنه، مع عطائه لتلامذته والدارسين الذين سطع نجمهم في علم الآثار على مدار عقود.
وقد أسعدني الحظ بأن تقاطعت أولى خطواتي العلمية في مجال دراسة الآثار، مع الدكتور عبد الحليم نور الدين، في النصف الثاني من الثمانينيات، وقد كان وقتها في أوج شهرته؛ فقد شغل منصب رئيس هيئة الآثار المصرية بالإنابة، في عام 1988، ثم رئاسة هيئة الآثار المصرية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار المصري في الفترة منذ 1993 إلى 1996، وقد سعيت لتسجيل رسالتي للماجستير مع الراحل في نهاية الثمانينيات، ورغم أنه لظروف خارجة عن إرادة كلينا؛ لم يكتمل إشرافه على رسالتي، إلا أنني أصررت على أن أسجل رسالتي للدكتوراه معه، بعد وفاة المشرف عليها وقتها، الدكتور محيي الدين عبد اللطيف.
علم الآثار
فرغم سوء الحظ الذي اكتنف بواكير علاقتنا سويا؛ إلا أن الرجل كان بعلمه وأخلاقه، عابرا لأي خلاف يذكر، وكان إصراري عليه؛ نابعا من إيماني بقيمته الاستثنائية، التي زادتها الأيام في نفسي إعزازًا، ولما تقادمت السنون وصارحته مصارحة التلميذ للأستاذ ببعض الكواليس وما دار فيها، وكيف لعبت الوشايات دورها للإيقاع بينه- كأستاذ كبير-، وبين تلميذه الذي يشق أولى خطاه في عالم المصريات؛ ذُهل الرجل، وتملكته الدهشة، وما كان منه إلا أن تعامل بلطف وكرم ونبل «الكبار»، وما يليق بهم.
وفي العقدين الأخيرين من حياة الراحل العظيم، تحسنت العلاقة بيننا جدا، حتى أنني ما زلت أذكر رنين صوته في الهاتف، وهو يبشرني بترقيتي لدرجة أستاذ مساعد، ثم وهو يبشرني بحصولي على الأستاذية، ولست أسوق أطراف حكايا وقصص شخصية لي معه، إلا بغرض التدليل على نبل الرجل، حتى في ساعات الخلاف، وأنه لم يكن أبدا متطرفا في خصومته، بل كان ودودا وعطوفا وشريفا.
ولا تكاد تجد واحدًا من جيلي، ممن حصلوا على الماجستير والدكتوراه في مجال الآثار، في نهاية الثمانينيات؛ إلا وقد كان منجذبا للدكتور نور الدين، لتواضعه، ولاختلاطه بطلابه، وذهابه معهم إلى مطاعم الأكلات الشعبية في أيام محددة من الأسبوع.. بما يذيب فوارق الرهبة المعطلة للعلاقة الصحية بين الطالب وأستاذه؛ ليرسي بدلا منها تواصلا علميا وجيليا، كله رفق ومودة، دون إهدار للجدية العلمية، ولا للاحترام المفترض للعلاقة بين الطرفين.. بما أحسب وأشهد أن مصر استفادت منه كثيرا.
وقد كان قادرا على نقل جذوة وطنِيَّته المتدفقة، وحرصه على آثار بلاده، لكل الذين درسوا معه، وتتلمذوا على يديه، وهو الذي صال وجال كثيرا في معارك إعلامية وسياسية لا تُنسى، لأجل تراث بلاده، حتى إن معاركه لأجل آثار مصر، التي كان يرى بعين البصيرة مخططات سرقتها وتخريبها؛ جرت عليه وبالا كثيرا من نافذين ولوبيَّات مصالح، في وقتها، إلا أنه كان ثابتا مدركا لأهمية ما يفعل، ومؤمنا بدوره الوطني والعلمي في حفظ الآثار، ونقل أسرارها وعلومها لأجيال من الباحثين والدارسين.
واليوم، وفي ذكرى مولده، الموافق للأول من يوليو، لا بد لنا من معشر الآثاريين، من إحياء ذكراه العطرة، أستاذا ومعلما، ومسؤولا رسميا، فكثير من الأكاديميين يرتبكون حين تُناط به مسؤولية أداء الوظائف العامة خارج أسوار الجامعة، إلا أن الدكتور عبد الحليم نور الدين، كان علما في المكتبة، وقاعات المحاضرات، وفي إنشاء وعمادة أقسام الآثار داخل مصر وخارجها، وفي توليه مسؤولية آثار مصر، من خلال أكثر من منصب رسمي.
لم يكن مسؤولا معزولا، ولا أكاديميًّا نظريًّا، بل كان «معجونا» بذكاء المصري النابه، قادرا على التحرك بين كل المهام التي أُنيطت به، والأدوار التي لعبها في الحياة العامة؛ بما جعله رقما استثنائيا في مشهد الآثار المصرية، طيلة ما يقارب من الأربعة عقود، لروحه الطيبة السلام في هذه الأيام المباركة، بما علَّم، وبما نقش في صدور أجيال كاملة من الآثاريين المصريين والعرب.