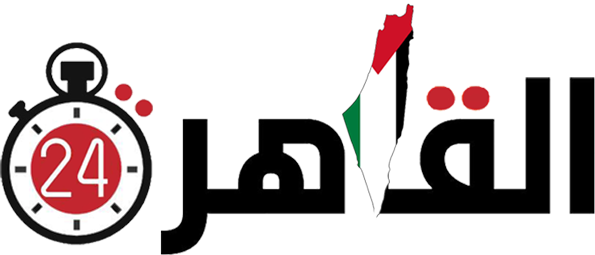اسمي مصطفى محمود.. وائل لطفي يواصل الإجابة عن سؤال: ماذا جرى في السبعينيات؟
"سآخذ القرآن ناحية العالم الغربي، سأقول إنه كتاب علم في الأساس، وإن حقائق العلم كلها موجودة في آيات قرآنية معدودة لا يزيد عددها عن عشرين آية.. تخيل عندما تقول للمسلم إن كل هذه الجهود والبحوث والتجارب والمعامل والعلماء والمليارات التي تنفق على التجارب والنظريات التي نعجز عن الوصول لها أو فهمها من الأساس، كل هذا موجود عندنا في عشرين آية فقط من القرآن الكريم.
أي فخر سيشعر به هذا المسلم؟".
هذا الجزء الذي قيل على لسان بطل رواية "اسمي مصطفى محمود" لكاتبها الصحفي وائل لطفي، الصادرة عن دار كلمة للنشر والتوزيع، شديد الخطورة وشديد الأهمية فهو يعطي أكثر من دلالة لتحول خطير حدث ليس فقط على مستوى الشخصية الرئيسة وبطل الرواية بل على مستوى وطن بأكمله.
في البداية يمكن أن نعتبر أن فترة السبعينيات بكل ما تحمله، من أهم الفترات في تاريخنا المعاصر، إن لم تكن أهم الفترات على الإطلاق، تحديدًا أن حجم التحولات التي حدثت في الشخصية المصرية وفي المجتمع والنظام المصري ككل لاتزال آثاره ممتدة حتى يومنا هذا.

فمنذ ليلة 28 سبتمبر 1970، حيث وفاة عبد الناصر، ومن ثم صعود السادات إلى قمة الهرم، نشأت حرب بين من سماهم السادات مراكز القوى، هذه الحرب التي حاول السادات فيها طمس كل ما له علاقة بالنظام والفترة الناصرية.. وحتى بعد حرب أكتوبر لم تهدأ هذه الحرب بل استمرت وازدادت شراستها، وتم استبدال الوجوه التي كانت تملأ عصر عبد الناصر بوجوه أخرى، وتم تبديل الخطاب بخطاب آخر، فبدلًا من محمد حسنين هيكل ظهر مصطفى محمود وبدلًا من ثروت عكاشة ظهر الشيخ الشعراوي، وبدلًا من نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وصلاح جاهين والأبنودي وكل مثقفين الستينيات ظهر في السبعينيات مشايخ شكلوا الخطاب العام والعقل الجمعي لعموم المصريين، مثل الشيخ كشك وعبد الحليم محمود والقرضاوي وزغلول النجار.

كل هؤلاء أخذوا يعملون على تمهيد البيئة والمناخ الصالح للخرافة والأكاذيب وهدم القيم التي زرعها ناصر حتى لو كانت قيم إيجابية مثل حب الوطن وتحرير الأرض، أو قيم تساعد على البناء، فنجد أن الشيخ الشعراوي على سبيل المثال لا يستحي أن يقول إنه سجد لله شكرًا عندما علم بهزيمة جيش بلده هزيمة خطيرة ومدمرة في 67.
في المجمل تم استبدال خطاب بخطاب آخر، يوفر الرضا لسامعه يقنعه أن كل الأمور من حوله في أحسن حال وأنه بالفعل عنصر من عناصر خير أمة أخرجت للناس، وأنه معه كتاب فيه كل العلوم التي يمكن أن يكتشفها الإنسان ليس فقط على ظهر الأرض بل بداخل مجرة درب التبانة.
وفي الرواية يغوص ويقتحم الكاتب شخصية واحد من هؤلاء الذين غيروا شكل العقل المصري وساعدوا في هذا التحول الخطير الذي حدث، وهو واحد من نجوم تلك الفترة.
فبعدما رفع السادات شعار دولة العلم والإيمان اتخذ مصطفى محمود من هذا الشعار اسمًا لبرنامجه، كان السادات يريد من مصطفى أن يكون هيكل الخاص به وبعصره، فكما كان محمد حسنين هيكل هو نجم الستينيات في الصحافة والإعلام، كان لا بد من خلق نجم جديد في السبعينيات، بل نجوم.. وبموسيقى لها واقع السحر استطاع مصطفى محمود أن ينجح في تحقيق رؤية السادات ومعه الشيخ الشعراوي الذي وصفه أنه أشطر منه بكثير:
"موسيقى ناي محمود عفت الحزينة أسرتهم، مثلها مثل موسيقى تتر حلقات الشيخ الشعراوي، كنا توأمين في التأثير، لكنه أشطر مني بكثير".
تتبع الرواية رحلة ظهور مصطفى ثم هبوطه ومراحل تحوله الكثيرة والمختلفة، ولكن الجدير بالذكر والتأمل هو علاقة مصطفى بجمال عبد الناصر الذي كان يكرهه كره العمى وبالسادات الذي كان سبب رئيسي ومباشر في كل ما وصل اليه، يقول مصطفى محمود داخل الرواية:
" أوقفني جمال عبد الناصر هذا عن الكتابة.. قال لإحسان عبد القدوس قل له يريح شوية.
استدعاني إحسان وقال لي أقعد شوية في البيت، قلت له ليه؟ ما هي جربمتي؟! ما ذنبي؟!
طلبني إحسان في مكتبه وقال لي معلهش اليومين دول خليك في البيت ولو احتجت أي حاجه اطلبني على التليفون وعبد الراضي هيجيب لك المرتب لحد البيت.. هل وصلت لهذه الدرجة؟ هل هناك إهانة لموهبتي أكثر من هذه التي يقوم بها رجال عبد الناصر؟ لا أعرف على وجه التحديد لماذا لا يحبني عبد الناصر؟!".
لا شك أن السادات بذكائه الفطري والمعروف كان قد لاحظ ما يعانيه مصطفى محمود من التهميش وسط الصخب الذي كان يملأ الوسط الثقافي والفني المصري في الستينيات، وربما أراد السادات أن يضم تحت لوائه شخصية رأى إنها ربما تمتلك بعض الموهبة والدهاء مثل شخصية مصطفى فضمها اليه، وبدأت علاقتهما حتى قبل أن يصل السادات إلى الحكم:
" لا شك أن حياتي تغيرت بعد أن اتصل بي السادات في أواخر 1969، وأبدى إعجابه بكتابي "القرآن محاولة لفهم عصري"..
السادات قال لي عبد الناصر مات يونيو 67 وما بقى أمامنا هو جثة عبد الناصر".
يثق السادات في مصطفى يصطحبه في رحلاته بعد أن أصبح رئيسًا للجمهورية، يرى مصطفى كل هذا الغرور الذي يصيب السادات حين يمدحه الأمريكان بعدما وصفوه بأنه أشيك رئيس في العالم وأن الله كان لا يمكن أن يجعل أحد يولد مع السادات في نفس اليوم.
تتبع الرواية مراحل تحول مصطفى محمود منذ كان طفلًا وحتى سنوات التهميش والموت، لنرى مدى الاضطراب الذي كان يعاني منه مصطفى منذ كان طفلًا حيث عمل مع (العوالم) والراقصات في شارع محمد علي، وذهب إلى اختبارات الكلية الحربية وبكى للطبيب حتى يكتب أنه غير لائق، وبعد دخوله كلية الطب نراه يقوم بإخفاء الجثث المستخدمة في التشريح أسفل سريره حتى لا تراها أمه.. فهي بحق رحلة مثيرة وعجيبة:
" كنت أحضر الأفراح والموالد في طنطا وأشارك بالغناء والعزف على العود، تعرفت على فرقة من حارة البغالة في شارع محمد علي.. عملت معهم مطربًا بالفعل لأن صوتي جميل وعشت الملذات التي يمكن أن يعيشها شاب في سني.. رافقت الراقصات ودخنت وجربت الخمور".
لم تتوقف مغامرات مصطفى محمود المراهق عند هذا الحد بل تجاوزت كل هذا بكثير، حتى إنه انشأ بالفعل جمعية "الكفار":
" بدأت أطرح أفكاري على صديق لي في المدرسة وأقنعته بأن نكون ملحدين، كان لدي تضارب بين ما قرأته عن الإلحاد وبين أفكاري القديمة، وكان عندي تساؤلات عادية، أقول لنفسي مثلًا.. إذا كان الموت نهاية كل شيء فما جدوى الحياة؟.. الفكرة أنني وقتها كنت أميل أكثر للاستعراض ولفت النظر، وهذه صفات أي فنان، وانا في الحقيقة فنان أكثر من أي شيء آخر لذلك أسست جمعية سميتها جمعية الكفار".
وبعد أن أصبح مصطفى محمود من نجوم عصر السادات، نراه يصطدم بغيره من نجوم نفس العصر، مثل الشيخ كشك الذي وقف على المنبر واتهم مصطفى بالازدواجية وبأنه منافق وأضاف كشك في خطبته:
"ولا ألوم الدكتور مصطفى محمود الذي كان شيوعيًا أيام الشيوعية ولما تأمركت مصر أصبح أمريكيًا، ولو دخلنا مع إنجلترا في حلف لأصبح انجليزيًا".
فالرواية وفي حقيقة الأمر هي جزء لا ينفصل عن مشروع كاتبها وائل لطفي، الذي يبحث ويحلل ويفكك جذور حالة التخلف الفكري والحضاري التي وصلت إليها مصر في العصر الحديث، فإذا نظرنا إلى كتابه السابق لهذه الرواية "دعاة عصر السادات" الذي فكك فيه الخطاب الذي تم تشكيله في عصر السادات من قبل رجال الدين، يواصل هذه المرة وائل لطفي تفكيك وتحليل وشرح ورصد عقل واحد من أهم الذين ساعدوا في تحول الفكر المصري وتشكيل وجدان الكثيرين في نفس حقبة السادات وهو الدكتور مصطفى محمود، حتى نتعرف داخل الرواية التي لا يمكن وضعها في تصنيف أو ضمها لجنس أدبي، وإن كنا نصنفها كرواية بل لأن بها ثمة راو وحيد هو مصطفى محمود، ولكننا أمام أقرب ما يكون إلى محاولة للاصطدام والالتقاء بمصطفى محمود آخر غير الذي عرفه كثيرون، مصطفى محمود الذي لا تختلف حقيقة آرائه عن أفكار كبار جماعات الإسلام السياسي، وكبار الدعاة للإرهاب وعلى رأسهم سيد قطب، فقد كان سيد قطب يقول إن مذاهب وفلسفات العصر هي الجاهلية الجديدة وإن على المسلمين اعتزالها ومعاملتها كطاغوت جديد وإعلان العداء لها، بينما مصطفى محمود وفي جوهر الأمر يوافق سيد نفس الرأي ويرى أننا بحاجة إلى ازدراء ما أنتجه الغرب من أفكار، ولكنه لم يعلن تكفير أحد أو وجوب قتال المؤمنين بهذه الأفكار.