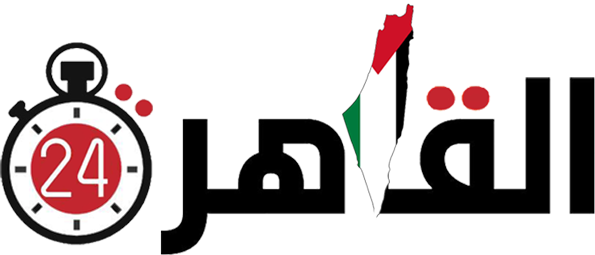سقوطُ الأندلسِ بدايةُ حروبِ الإبادةِ وتخريبِ ركائزِ الهُويّةِ
سقوطُ الأندلسِ يُعدُّ واحدًا من أبرزِ الأحداثِ في تاريخِ العصورِ الوسطى، وقد شكَّلَ نقطةَ تحولٍ جوهريةٍ في تاريخِ إسبانيا وأوروبا بشكلٍ عام. استمرت الحضارةُ الإسلاميةُ في الأندلسِ لقرونٍ، حيث ازدهرتِ الفنونُ والعلومُ والثقافةُ في ظلِّ حكمِ المسلمين. إلا أنَّ هذا العصرَ الذهبيَّ انتهى بشكلٍ دراميٍّ مع استيلاءِ الملوكِ الكاثوليك على آخرِ معقلٍ إسلاميٍّ في غرناطة عام 1492. هذه الأحداثُ لم تكن مجردَ نهايةٍ لحكمٍ سياسيٍّ، بل كانت بدايةً لفترةٍ من الاضطهادِ والتغييرِ القسريِّ لهويةِ المجتمعِ الأندلسي. أُجبرَ المسلمون على التحولِ إلى المسيحيةِ تحتَ التهديد، وتم طردُ الموريسكيين في النهايةِ، مما أدى إلى تدميرِ ركائزِ الهويةِ الإسلاميةِ والثقافيةِ في المنطقة. وقد وظَّفت الكثيرُ من الأعمالِ الأدبيةِ مشاهدَ دراميّةً تحملُ قضيةً نسقيةً تاريخيةً عن الأندلس، حيث تناولت قضيةَ اللعنةِ الكنعانيةِ التي تسببت في إِبادةِ أعراقٍ وشعوب. المقصدُ الذي ترغب المقالةُ الإشارةَ إليه هو (حروب الإبادة) أنَّ المستعمرَ لديه نقصُ براهينَ عن نظافةِ أيديه من دماءِ المدفونين تحتَ أرضهِ، حتى المتبقي منهم لم يسلموا من عملياتِ التبشيرِ التي قام بها الأوروبيون تجاههم، لم يحصلوا على حريتهم، بل بقوا عبيدًا في نظرِ المستعمرين، وآل الأمر لحرقهم لتنظيفِ العرقِ البشري منهم، على الرغمِ أنهم اعتبروهم في بدايةِ الأمر أرواحًا عاقلةً تستحقُّ الخلاصَ الكاملَ أمامَ ربِّ المسيحية. أيضًا عن رمي الموريسكيين خلفَ البحرِ في شمالِ إفريقيا، فرميُ الموريسكيين خلفَ البحرِ في شمال إفريقيا يشيرُ إلى حدثٍ تاريخي يعودُ إلى القرنِ السادس عشر، فالموريسكيون هم المسلمون الذين يعيشون في إسبانيا خلال فترةِ الحكمِ الإسلامي.
وبعد الاستيلاءِ النهائيِّ للمملكةِ الإسبانيةِ على الأراضي المسلمة في القرنِ الخامس عشر، بدأت حملاتُ الاضطهادِ ضد المسلمين المتبقين (الموريسكيين). في عام 1609، أمر الملك فيليب الثالث بترحيلِ الموريسكيين إلى مناطقَ أخرى من إسبانيا أو ترحيلهم إلى المناطقِ الإسلاميةِ خارجَ الحدودِ الإسبانية. وقد تم تنفيذُ هذا الأمرِ على نطاقٍ واسعٍ في الفترةِ من عام 1609 إلى عام 1614 ميلاديًا. وقد وصل العديدُ من الموريسكيين إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر وتونس وليبيا؛ حيث استقروا في تلكَ المناطق ودمجوا في المجتمعاتِ المحلية، وقد تم رميهم "خلفَ البحر" بمعنى نقلهم بالقوةِ عبرَ البحر، ذلك ما يسمى بالــ (التهجيرِ القسري) إلى بلدانٍ أخرى بعيدًا عن إسبانيا.
نصل إلى أنَّ سقوطَ الأندلسِ نسقٌ تاريخيٌّ يدخلُ ضمن حروبِ الإبادةِ المنظمة، ومن ثَمَّ تلك التجربةُ كانت مؤلمةً للموريسكيين وللعديد منهم، فقد واجهوا صعوباتٍ في التكيفِ مع بيئتهم الجديدة وفقدانِ هويتهم الثقافية والاجتماعية. وقد وضح ذلك عبدالله إبراهيم؛ حيث قال: وإذا كان فضاءُ السردِ التاريخي قد ازدحمَ بأسماءٍ عربيةٍ في الجيل الأول من شخصيات الرواية جيل الأجداد، مثل: جعفر، وحسن، ونعيم، وسعد، ومريمة، وسليمة، وحامد، وعائشة، فلا نجدُ في الجيل الأخير جيل الأحفاد، غير: إدواردو، وروبرتو، وفرناندو، وكارلوس، وجلوريا، ولوسيا مورينا، وماريا بلانكا، وإسبيرانزا، ودييجو، وفرانسيسكو، ولويس. فبمرورِ مئةِ عامٍ جرى تغييرُ هويةِ الأندلسِ العربيةِ إلى هويةٍ أخرى. إنَّ وفرةَ أسماءٍ عربيةٍ في البدايةِ تقابلها وفرةٌ عجميةٌ في النهاية.
يمكننا إذًا أن نستدعي من التاريخ مجموعةً من أنساقِ الإبادةِ العرقيةِ والجماعيةِ التي مارسها المُستعبِدون ضدَّ غيرهم من الشعوب، فهي أيضًا تعكسُ عقليةَ الرجل الأوروبي في كل زمانٍ ومكان، ونظرتَه للشرق ومعتنقي الإسلام. إذ دخلت جيوشٌ قشتاليةٌ المملكةَ التي شهدها المسلمون آخر ممالك الأندلس (غرناطة) عام 1492م، فلم يَعُدْ أبو عبد الله الصغير ملكًا، وقد ذكرت العديد من الروايات التي تناولت قضيةَ غرناطة المشهدَ التاريخيَّ الذي لا يُنسَى؛ حيث عائشة الحرة أم أبي عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر (بني نصر) وآخر ملوك غرناطة في الأندلس. فقد قام بتسليم آخر ممالك المسلمين لفرديناند وإيزابيلا، ملكي إسبانيا عام 1492م، فلما خرج من المملكة ألقى نظرةَ الحسرةِ الأخيرة باكيًا، فأنشدت أمه مُتحسرة:
ابكِ كالنساءِ مُلكًا لم تحافِظ عليه كالرجال
وقد ذُكر البيت الشعريُّ في العديد من الكتبِ التاريخيةِ، والمراجع لكن لا يوجدُ تأكيدٌ تاريخيٌّ هل قالت عائشة أم محمد الصغير هذا البيت أم لا. نستكمل فقد دخلت جيوشٌ قشتاليةٌ المدينةَ التي شهدها المسلمون إثر سقوط غرناطة، وعام 1492 فلم يعد أبو عبد الله الصغير ملكًا. ومرت الأعوام وجرى على إثره تغييرُ الهُويّةِ إلى أخرى غير عربية. وكان الأندلسيون المتحدثون بالعربية يخفون معرفتهم بها؛ خوفًا من التنكيلِ بهم أو حرقهم أحياءً، فالمستعمر الأوروبي كان يمارسُ أبشع أنواع التعذيب ضد المسلمين، وعرض أمين معلوف في كتابه (الهويات القاتلة)، أن اليهود الموريسكيين الذين يعتبرون من الهنود حافظوا على دينهم أكثر من المسلمين أنفسهم، كل ما حدث يدلُّ على محاولاتِ محوِ الثقافةِ التاريخيةِ والدينيةِ التي تُميزُ الشعوب. هذا يسمى بــ (تخريبِ ركائزِ الهُويّة)، فقد شرع القشتاليون في بدايةِ الأمر بعقدِ اتفاقيةِ صلحٍ تشبه كثيرًا ما يعقده المسلمون عند عمليات الفتح للبلاد غير المسلمة، لكن مع المغايرة، فالمسلمون لا يعتدون ولا يقتلون شيخًا ولا امرأةً ولا طفلًا، على عكس ما فعله المستعمر.
كانت بنود المعاهدة الحفاظَ على المقدسات الإسلامية، ومنعَ اعتناقِ المسيحية ما دامَ قُبلَتْ بالرفض، يملكون عقاراتهم ودكاكينهم وأملاكهم دون المساسِ بهم، ويسير المسلمُ في بلادِ النصارى آمنًا على ماله وعرضه، ولا يُمنع مؤذنٌ ولا مُصلٍّ ولا صائمٌ ولا غيره من أمورِ دينه. وبعد مرورِ أقل من شهر، ومع خروجِ الخليفةِ المسلم وهو يبكي على سقوط غرناطة آخر إمارات المسلمين بالأندلس، تُنقضُ المعاهدة، ويُنكَّل بالمسلمين واليهود والموريسكيين الهنود، ويصدر فرديناند بيانًا بترحيلهم خلال مدةٍ معينةٍ أقصاها أسبوع، ومن لم يرحل، إِمّا أن يعتنقَ المسيحيةَ مع الأخذِ في الاعتبار إن كان مسيحيًا خالصًا صافي (العرق) فيصح تبديلُ ديانته، أمّا إذا كان مسلمًا يتوخى الحذر فيُشهِر مسيحيته، لكنه سرًا يمارس الطقوسَ الدينيةَ الإسلاميةَ، يُعرَضون للإعدام في ميادينَ عامة، إما الحرقِ حيًا أو تُقطَعُ رأسه، ومع مرور الوقت أباد القشتاليون جميع المسلمين، من خلال خططِ إبادتهم، ووضع خططِ التغييرِ الجذري لبنيةِ المجتمع الغرناطي.