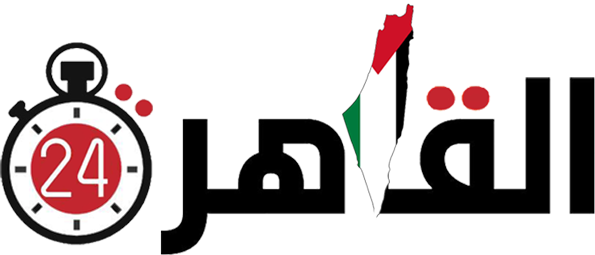سيناريوهات المستقبل 2.. الدورات الاقتصادية
أعلم أن أسلوب الصدمة قد يكون مثاليا في إثارة الانتباه، لكني في الواقع لا أتعمد ذلك فيما أطرحه ضمن سلسلة سيناريوهات المستقبل، خاصة وأنني أستند بشكل فعلي على أرقام ومؤشرات وحقائق أحاول من خلالها قراءة ما ينتظر الدولة من الناحية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.
وبما أن أغلب رد الفعل على المقال الأول من السلسلة الطائرة الورقية جاهزة للإقلاع، جاءت متسائلة عن مفهوم الدورات الاقتصادية التي تمرُّ بها الدول وكذا الأسباب والمؤشرات التي استندت إليها في الحديث عن أن الدولة على مشارف دورة اقتصادية سيئة، وجدت أن هناك حاجة لمزيد من الشرح المستفيض.
وبداية فإن الدورات الاقتصادية، تعد من المفاهيم الأساسية في علم الاقتصاد، حيث تعكس الحركات التذبذبية في النشاط الاقتصادي للدول على مدى فترة من الزمن، كما تعتبر جزءًا طبيعيًا من الاقتصاد، وتتألف عادةً من مراحل مختلفة تتكرر بشكل دوري، مع إمكانية للتنبؤ بها مسبقا وفرصة للاستعداد لها.
وتنقسم الدورات الاقتصادية إلى الدورات الجيدة الصاعدة التي تحدث في أوقات الانتعاش أو التوسع، عندما يشهد الاقتصاد نموًا في الناتج المحلي الإجمالي أو حتى استقرارا يُمكن من زيادة الاستثمارات واستقرار الأسعار، وهناك نوع آخر وهو الدورات السيئة الهابطة، والتي تحدث حينما يواجه الاقتصاد فترات من الركود أو الانكماش، جراء الأزمات المختلفة ومنها انخفاض الإنتاج وارتفاع البطالة والتضخم وغيره.
وقد لوحظت التقلبات في النشاط الاقتصادي بانتظام كبير منذ بداية القرن الماضي، مما حفز الجهود الأكاديمية لتحديد وقياس وفهم الدورات الاقتصادية، مع محاولات للإجابة عن تساؤلات منطقية عن كيفية وآلية تحرك الاقتصاد، وأسباب تحرك الاقتصادات الرأسمالية بشكل عام في مسار النمو المستدام، وكذا أسباب تلاحظ حدوث فترات من النمو المتزايد ولحظات من الانكماش العميق.
وقد ظهرت خمس مدارس فكرية تقدم تفسيرات بديلة للدورات الاقتصادية: الاقتصاد الكينزي، والنظرية النقدية، والاقتصاد الكلاسيكي الجديد، ونظرية الدورة الاقتصادية الحديثة، والاقتصاد الكينزي الجديد.
والأمثلة العملية من تجارب الدول عديدة، منها ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في الكساد العظيم عام 1929 وهكذا عام 2008 حين بدأ الركود الاقتصادي العالمي بسبب أزمة الرهن العقاري، ثم بدأ الاقتصاد في التعافي بحلول عام 2009 بفضل سياسات التحفيز النقدي والمالي الضخمة التي طبقتها الحكومة، إلى أن جاءت جائحة كورونا في 2020 فدخل الاقتصاد في مرحلة ركود جديد.
في مصر للأسف، تتسم الدورات الاقتصادية بالتسارع منذ منتصف القرن الماضي، متأثرة بالتغيرات الداخلية والخارجية والسياسات الاقتصادية المتبعة منذ الركود في نهاية الستينيات، بسبب تحديات الانخفاض في الإنتاجية، والتضخم، وزيادة العجز في الموازنة العامة، وتكاليف الحرب، وهي الدورة التي استمرت حتى بداية السبعينيات تقريبا.
ومع سياسة الانفتاح في عهد الرئيس السادات، ودعم الاستثمارات الأجنبية والخاصة، وتقليل دور القطاع العام، شهدنا حالة من النمو الاقتصادي السريع نسبيًا وزيادة في تدفقات رأس المال الأجنبي، لكن بسبب تراكم الديون وزيادة الاعتماد على المعونات الخارجية، وارتفاع نسبة الفقر، مرت الدولة بفترة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك، فقد جرت محاولات لمواجهة هذه التحديات وتم تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي من خصخصة وتخفيض الدعم وتحرير سعر الصرف، بما ساعد في تحسين المؤشرات الاقتصادية، مثل زيادة معدل النمو وتقليل العجز في الموازنة، لكن النتيجة على الأرض لم تكن مرضية بسبب البطالة وزيادة نسب الفقر، وقبلهما ما يعرف برأسمالية المحاسيب وهي للأسف كأس دائر في مجتماعتنا تبدو وكأنها خُلقت لتبقى.
ومن بعد 2011، دخلنا في دورة اقتصادية عنيفة نتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية وتعرض السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات لتدهور حاد وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، واستمرت محاولات الإصلاح التدريجي حتى عام 2016، مع تحرير سعر الصرف وبرنامج خفض الدعم والاعتماد على الأموال الساخنة، والقروض الخارجية من اجل إحداث مُنتج تنموي تركز بشكل كبير على البنية التحتية، وكانت الفكرة السائدة أن هذا التوسع الشديد للغاية في الإنفاق العام سيكون له آثار استثمارية وهو ما لم يتحقق، ورتب نتائج كارثية.
فبينما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 73 مليار دولار في الفترة من 2011 لـ 2022، قد وصل الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار في ذات الفترة، وبينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 53.5 مليار دولار في الفترة من 2000 لـ 2010 بلغ الدين الخارجي 35 مليار دولار في ذات الفترة، وهو ما يشرح بوضوح لب المشكلة وأن الاعتقاد السائد بأن الاستدانة بغرض تعزيز البنية التحتية ستجلب التنمية، لم تؤدِ المطلوب.
وتحت وطأة الدين الخارجي الكبير وخروج الأموال الساخنة جاءت الدورة السيئة في منتصف 2021، وهو ما طرحته تفصيلا في المقال السابق.
وفي تقديري فإن الفترة التي يمر الاقتصاد المصري الآن هي أقرب لما مرّ بها خلال 2017، وأهم ما يميزها الاعتمادية الكبيرة على الأموال الساخنة وزيادة الإنفاق على مشروعات غير مدرة للعملة، مع ارتفاع معدلات التضخم، ناهيك عما تشهده طائرتنا الورقية هذه المرة من رياح معاكسة متمثلة في انحسار إنتاج الغاز وإيرادات قناة السويس، وهو ما يضر موارد الدولة الدولارية، رغم أنه يبدو أن هناك اعتمادية للدولة الآن على قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة مما يعني استقرار وقتي لسعر الصرف بفضل استمرار التدفقات من النقد الأجنبي.
وقد وصف الاقتصادي بريما شاندرا أدهوكورالا، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية الأسترالية هذه المشكلة في بحث تناول الأزمة الاقتصادية الآسيوية، حيث رأى أن سلسلة الأزمات الاقتصادية التي شهدتها اقتصادات الأسواق الناشئة في تسعينيات القرن العشرين، وما أعقبها من أصداء عالمية، قد أضافت زخمًا جديدًا إلى المناقشة الدائرة حول كيفية التوفيق بين حركة رأس المال الدولية والاستقرار الاقتصادي المحلي والأولويات التنموية في الاستثمار في البلدان النامية، حيث خلص بيرماشاندرا إلى أن الحماس غير المشروط لتعزيز تدفقات رأس المال لمساعدة التقدم الاقتصادي في هذه البلدان قد أفسح المجال أمام التركيز الجديد على إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بالتوفيق بين حركة رأس المال الدولية والاستقرار الاقتصادي المحلي والأولويات التنموية.
وفي قلب هذا التركيز الجديد يكمن التأكيد المتجدد على الحكمة التقليدية حول الحاجة إلى التعامل مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل منفصل عن الأشكال الأخرى من تدفقات رأس المال أغلبها الأموال الساخنة في تصميم السياسات الوطنية لمراقبة تدفقات رأس المال، وهو الدرس الذي تأبى مصر أن تتعلمه رغم تداعياته المُجربة دوليا ومحليا آخرها 2022 والمحفوفة دائما بالمخاطر.
ختامًا.. فالوعي بخصائص الدورة الاقتصادية التي تمر بها الدولة أمر في غاية الأهمية حتى يكون هناك إمكانية للتكيف المستمر مع الظروف المتقلبة، وكذا اتخاذ قرارات أكثر استنارة للتعامل مع ما هو قادم وصولا إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام ومستعد للتكيف مع المتغيرات.
وللأمانة، فالدولة المصرية قد حاولت ذلك في بداية الألفينيات لكن سرعان ما تخلت عنه وتجاهلته على مدار العقدين الماضيين، وربما قد حان الوقت للحديث عنه بآليات واضحة في المقال القادم.